[نقاش:] هنا مرّت الحكاية
![[نقاش:] هنا مرّت الحكاية Empty](https://2img.net/i/empty.gif) [نقاش:] هنا مرّت الحكاية
[نقاش:] هنا مرّت الحكاية
صاحبي، وهو فنّي في صِفَاحة السّيارات، أو صفّاح سيّارات Tôlier، مرّ كالعديد من الصّناعيين ـ الحرفيّين من مسارات التّكوين التّقليديّة، صبيّ فصانع فقلفة فمعلّم صاحب محلّ، وتعلّم بالتّالي الصّنعة حسب الحلقات التّكوينيّة التي يقتضيها تنظيم الحرف في المجتمعات التّقليديّة.
صاحبنا هذا منقطع عن تعليمه منذ مراحله الأولى، ولكنّه كان شاهدا على أقرانه الذين أسعفهم نجاحهم المدرسي فتموقعوا في الإدارات وحصلوا على مناصب طالما اعتدّوا باحتلالها وافتخروا بذلك بين أصدقائهم وأقاربهم، فكانوا مفخرة لتلك الأسر التي ترى فيهم نوعا من الرأسمال الرّمزي في مجتمع بدأ في تثمين كل ما له علاقة بالرأسمال المدرسي والعلائقي.
لقد بقيت المدرسة والنجاح المدرسي المساحة الفراغ في وجدان المعلّم محمّد، المساحة التي تمنّى لو ملأها حتّى لا يبقى له نقص ما في هويّته الاجتماعيّة، لذلك وكأمثاله في هذه الوضعيّة كان لا بدّ وأن يُنجِحَ الرّهان مع أبنائه وبناته.
بإصرار وبكثير من العناد، تمكّن سي محمّد من كسب رهان نجاح أبنائه، لكنّه في المدّة الأخيرة وقف عند استنتاج رهيب قرّر معه اتّخاذ إجراء يقطع به مع حلمه.
الحكاية بدأت مؤخّرا في شهر ديسمبر 2014، فمن بين أبنائه الأربعة، صبيّة نجحت بامتياز في الإجازة ثمّ في الماجستير، اختصاص حقوق، وهي الآن بصدد إعداد الدّكتوراه في نفس الاختصاص، وابن نجح في الباكلوريا منذ سنتين ويدرس بإحدى الكلّيات بصفاقس. تمكّنت البنت من تثبيت نفسها كمتعاقدة في كلّية الحقوق، ولكنّها كانت تتابع المناظرات الوطنيّة في الإدارات التونسيّة التي تطلب اختصاصها، وقد كانت تنجح مع القلّة القليلة في اختبارات الكتابي، غير أنّها كانت «تسقط» في المواجهة الشفاهية. كان صاحبي يحدّثني دائما كلّما رجع من تونس العاصمة، وبكثير من الحسرة والحرقة، عمّا خلّفته المناظرة في نفس ابنته من يأس وقنوط وانعدام الثّقة في البلاد وفي المستقبل، ويؤكّد لي استعداده اللاّمشروط لمساندتها والتّضحية معها. لقد كان فعلا يضحّي معها، فكلّما اقتضى الأمر منه التّحوّل إلى العاصمة لإجراء الاختبار الكتابي أو الشّفاهي تراه يبحث عن كراء للمدّة التي يستغرقها الامتحان والتي قد تصل إلى أسبوع في بعض الأحيان، فكان يغلق محلّه طوال تلك المدّة، مع ما يفرضه ذلك من تأجيل لكل أعماله وخسارة في الجوانب المالية وفي التزاماته مع حرفائه، ومن مصاريف غير محدودة مدّة الامتحان. لكنّه كان مثل المقامر، يلعب ويراهن على إمكانيّة الرّبح بشكل متواصل، ولا تهمّه الخسارة الوقتيّة، وكان حين يعود يسرّ لي بضعف ثقته في النّجاح بسبب غياب الشّفافيّة عن تلك الامتحانات، وبما يروج عن بيع وشراء للذّمم وعن قائمة النّاجحين المعدّة سلفا في نسبة 90٪ منها. كنت واثقا من صحّة أغلب ما يدّعيه، لكنّني كنت أحفّزه على انتظار مفاجأة ما، فلا يعقل أن يتمّ قبول هذه النسبة المرتفعة بمثل تلك الطّرق الملتوية والمتحايلة، فقد تتميّز ابنته بشكل استثنائي وتجد نفسها بين الناجحين باستحقاق. إلاّ أنّه في هذه المرّة الأخيرة قرّر قلب الطاولة بما عليها، فلم يعد قادرا على متابعة ما يحصل بسلبيّة، وقلب الطّاولة هنا لن يكون على مفسدي فرحته ولا على المتسبّبين في تعفّن نظام الانتدابات في الوظيفة العمومية ولا على المشرفين على المناظرات العموميّة ولن يكون بتشكيل خليّة أو جمعيّة تدعو لكشف الحقائق وشفافيّة المعلومة والامتحانات أو بمراسلة مجهولة الهويّة إلى السّيد رئيس الجمهوريّة القادم للتّوّ إلى قصر قرطاج، كلاّ لن يكون الأمر كذلك، بل سيكون قلب الطّاولة على أحلام طالما سكنته، على هويّة فهم أنّه غير قادر على نحتها باستقلالية عن نظام فاسد مهترئ ومتآمر. لقد قرّر صاحبي أن يقنع ابنه بكلّ الوسائل أن ينقطع عن الجامعة وأن يأتي معه إلى ورشته يتعلّم في كنفها كيف يفتّق أحجبة العالم وأسرار الكينونة الاجتماعية بعيدا عن أوهام طالما سوّقت لها أجهزة الأنظمة القائمة لتبرير أسباب وجودها وتشريع أسس التراتب الاجتماعي القائمة.
هنا مرّت الحكاية من مجرّد قصّة شخصيّة تهمّ أحداثها مواطنا بعينه إلى قصّة مجتمع ونظام بالنّسبة لي، إنّها قصّة المدرسة والتّمايز الاجتماعي وتحوّلات البنية الاجتماعية والطّبقيّة في بلادنا، والتي انبثقت من سياقات تحوّلاتها انتفاضة الشّعب في ديسمبر 2010 وبقيت نهاياتها مفتوحة لم ترتسم بعد ملامحها الأساسيّة.
لقد أبرز العديد من الدّارسين، وعلى رأسهم علماء الاجتماع، كيف أنّ المدرسة كانت من بين أهمّ مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة، وأنّها بوحدة برامجها وتساوي الحظوظ بين كلّ التّلاميذ مهما كانت انتماءاتهم الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا كبيرا في التّقليص من حدّة الصّراعات الاجتماعية وتعطي الفرصة للجميع للصّعود الاجتماعي والتّموقع في أعلى المراتب الوظيفيّة، وقد عزّز من هذا الدّور اعتبار الشّهائد المدرسيّة والجامعيّة جوازات المرور إلى المواقع المطلوبة في سلّم الوظيفة العموميّة خاصّة، ولكن كذلك في مواقع العمل والإشراف في القطاع الخاصّ، سواء في تونس أو في العالم. لقد جعلت المدرسة في تونس، وطيلة عقود من الزّمن، من الرّأسمال المدرسي مفتاح النّجاح الاجتماعي، وكانت حظوظ الجميع شبه متساوية في الحصول على هذا الرّأسمال، لكنّ ذلك ومنذ نهاية القرن الماضي تقريبا لم يعد القاعدة، وبدأنا في تعداد الآلاف من العاطلين عن العمل من بين أصحاب الشهائد الجامعيّة، فكثر الانقطاع المدرسي في مراحل الدّراسة الأولى، وبدأت احتجاجات أصحاب الشهائد بصفة فردية في البداية ثمّ أنشؤوا لهم اتّحادا يجمعهم ويدافع عنهم وعن قضاياهم، ولكنّ الحلول كلّها كانت وقتيّة ولم ترتق إلى مستوى الانتظارات، لأنّ المخطّطين لم يفهموا بعد أنّ أزمة المدرسة إنّما تعكس قبل كلّ شيء أزمة نظام في كلّ مستوياته.
إنّ من ينظر اليوم إلى المناظرات التي أشرنا إليها وغيرها يفهم جيّدا أنّنا دخلنا بعمق في منطق السّوق، السّوق الذي لا تعرض فيه إلاّ السّلع التّبادليّة، والتي لكلّ منها ثمن، وتدخل في منافسة وفي منطق العرض والطّلب، وقوانين المنافسة هنا لا تحترم، بل هي توضع لخرق قبل كلّ شيء من قبل واضعيها. لقد اكتسح السّوق اليوم كلّ المجالات الإنتاجية، المادية منها والرمزيّة، ولم تكن المدرسة ولا القيم العامّة وما ارتبط بها بمعزل عن هذا الاكتساح. فكانت النّتيجة تهاوي قيمة التساوي في الحظوظ المدرسيّة تماما، وخاصّة مع تحويرات في الأنظمة التربوية لا تزال تتمّ بعيدا عن الصّيغ التّشاركية، التي يكثر الحديث عنها تقليدا، ولكن دون تطبيق على أرض الواقع، فدخل التّعليم الخاصّ في كلّ المستويات، ومنذ المراحل ما قبل المدرسيّة وإلى حدود الجامعة، منافسا للتعليم العمومي المتهاوي في بنيته الأساسيّة وفي الفوضى التي تسوده تنظيما وبرامج، فضلا عن تمكين أصحاب الاستثمار في التعليم الخاص من استغلال إمكانات الدّولة وتجهيزاتها وحتّى مواردها التقنية والبشريّة، دون ثمن يعادل حقيقة تلك الإمكانات المستغلّة.
وحدّث أيضا ولا حرج عن الدّروس خارج المدرسة، وعن هذا الرُّهاب الذي يعاني منه التلاميذ والطّلبة وأولياؤهم، وهو يستنزف كلّ طاقاتهم الذّهنية والزّمنية والجسديّة والماليّة، هذا الطّاعون الذي يزيد تدريجيا في تعميق الهوّة بين حظوظ أبناء الشعب في تلقّي خدمات احتكرتها الدّولة لعقود، وفجأة سادتها الفوضى ودخلها «الموازي»، مثلما اقتحم كلّ مجالات النّظام في تونس، حيث بتنا نجد الموازي في كلّ شيء، كالطفيليات، في الصحة والنقل والتعليم والاقتصاد والرياضة... وهذا هو الخطر الحقيق برأيي، وهو أن يكون الأمر ممنهجا، أمر إحلال الشرعي بما لا شرعية له سوى التفكير في هدم المكتسبات وإسقاط أسس البناء كلّه على رؤوس الجميع فتكون الفوضى الخلاّقة مبرّرا لإحلال واقع آخر يكون فيه المهندسون أولئك الذين فشلوا لعقود بل ولقرون في تأسيس بدائلهم التي لم تجد لها مكانا في واقع لم يفقهوا بعد أنّه في تغيّر مستمرّ ويقتضي بالتالي أشكالا تنظيميّة متغيّرة ومتطوّرة باستمرار.
تحوّلت المدرسة هكذا، ومعها الجامعة بالطّبع من فضاءات للتأهيل للمواطنة إلى مؤسّسات استدراج وتهدئة وتسويق للأوهام، فيكون الاصطدام بين المنشود والموجود عنيفا، وتُضحي المؤسسات التي يفترض أنّها تنشر المساواة والسلم الاجتماعيين، مبرّرة للعنف الرّمزي المنهجي، لذلك كان الرّدّ أعنف، بردود الفعل المتمحورة حول الذّوات، وحول الأجساد (مخدّرات، عنف جسدي، انتحار، قوارب الموت...) إلى ردود على المحيط القريب («غزوات» لشلّة من معهد على أخرى من معهد آخر، تحطيم وكسر للمنشئات العموميّة وللتجهيزات داخل المعاهد، بذاءة مستشرية ومقصودة في الفضاء العام وفي المدرسة والجامعة والملعب...)، فكيف يمكن أن نقيّم مآلات هذا الوضع؟ إنّه الفشل التّامّ للأهداف التي من أجلها تأسست المدرسة والجامعة، إنّه الانحراف عن المسارات التي كان يفترض أن تسلكها هذه المؤسسات خدمة للمجتمع وللأجيال القادمة.
إنّنا أيها السّادة والسيدات أمام وضع لم يعد يحتمل الانتظار أكثر، وأخشى ما نخشاه أن نفيق يوما فنجد كلّ ما بناه آباؤنا أثرا بعد عين. لقد بدأت الهجرة الفعليّة الممهّدة للفراغ، هجرة العقول، فهجرة المدرّسين بناة تلك العقول فبحث أبنائنا عن تعليم أفضل خارج الحدود. ولعلّكم بدأتم تقرّون بضرورة الإصلاح، اصلاح المنظومة التربوية والجامعيّة مثلما شُنّفت أسماعنا بسماعه منذ سنوات، فنجيبكم أنّ الأمر لا يقتضي إصلاحا، إنّه يتطلّب ثورة، فأن نصلح مؤسسة في محيط ملوّث كما لو قمنا بإصلاح غرفة في بناء متهاو. لن يصلح التّعليم ما دامت الإدارة على تلك الدّرجة من الانخرام، وما دام النّظام القائم فقد الموجّهات التي يجب أن تقود لخدمة المجتمع بأكمله لا خدمة مصالح فئات ضيّقة دون أخرى.
صاحبنا هذا منقطع عن تعليمه منذ مراحله الأولى، ولكنّه كان شاهدا على أقرانه الذين أسعفهم نجاحهم المدرسي فتموقعوا في الإدارات وحصلوا على مناصب طالما اعتدّوا باحتلالها وافتخروا بذلك بين أصدقائهم وأقاربهم، فكانوا مفخرة لتلك الأسر التي ترى فيهم نوعا من الرأسمال الرّمزي في مجتمع بدأ في تثمين كل ما له علاقة بالرأسمال المدرسي والعلائقي.
لقد بقيت المدرسة والنجاح المدرسي المساحة الفراغ في وجدان المعلّم محمّد، المساحة التي تمنّى لو ملأها حتّى لا يبقى له نقص ما في هويّته الاجتماعيّة، لذلك وكأمثاله في هذه الوضعيّة كان لا بدّ وأن يُنجِحَ الرّهان مع أبنائه وبناته.
بإصرار وبكثير من العناد، تمكّن سي محمّد من كسب رهان نجاح أبنائه، لكنّه في المدّة الأخيرة وقف عند استنتاج رهيب قرّر معه اتّخاذ إجراء يقطع به مع حلمه.
الحكاية بدأت مؤخّرا في شهر ديسمبر 2014، فمن بين أبنائه الأربعة، صبيّة نجحت بامتياز في الإجازة ثمّ في الماجستير، اختصاص حقوق، وهي الآن بصدد إعداد الدّكتوراه في نفس الاختصاص، وابن نجح في الباكلوريا منذ سنتين ويدرس بإحدى الكلّيات بصفاقس. تمكّنت البنت من تثبيت نفسها كمتعاقدة في كلّية الحقوق، ولكنّها كانت تتابع المناظرات الوطنيّة في الإدارات التونسيّة التي تطلب اختصاصها، وقد كانت تنجح مع القلّة القليلة في اختبارات الكتابي، غير أنّها كانت «تسقط» في المواجهة الشفاهية. كان صاحبي يحدّثني دائما كلّما رجع من تونس العاصمة، وبكثير من الحسرة والحرقة، عمّا خلّفته المناظرة في نفس ابنته من يأس وقنوط وانعدام الثّقة في البلاد وفي المستقبل، ويؤكّد لي استعداده اللاّمشروط لمساندتها والتّضحية معها. لقد كان فعلا يضحّي معها، فكلّما اقتضى الأمر منه التّحوّل إلى العاصمة لإجراء الاختبار الكتابي أو الشّفاهي تراه يبحث عن كراء للمدّة التي يستغرقها الامتحان والتي قد تصل إلى أسبوع في بعض الأحيان، فكان يغلق محلّه طوال تلك المدّة، مع ما يفرضه ذلك من تأجيل لكل أعماله وخسارة في الجوانب المالية وفي التزاماته مع حرفائه، ومن مصاريف غير محدودة مدّة الامتحان. لكنّه كان مثل المقامر، يلعب ويراهن على إمكانيّة الرّبح بشكل متواصل، ولا تهمّه الخسارة الوقتيّة، وكان حين يعود يسرّ لي بضعف ثقته في النّجاح بسبب غياب الشّفافيّة عن تلك الامتحانات، وبما يروج عن بيع وشراء للذّمم وعن قائمة النّاجحين المعدّة سلفا في نسبة 90٪ منها. كنت واثقا من صحّة أغلب ما يدّعيه، لكنّني كنت أحفّزه على انتظار مفاجأة ما، فلا يعقل أن يتمّ قبول هذه النسبة المرتفعة بمثل تلك الطّرق الملتوية والمتحايلة، فقد تتميّز ابنته بشكل استثنائي وتجد نفسها بين الناجحين باستحقاق. إلاّ أنّه في هذه المرّة الأخيرة قرّر قلب الطاولة بما عليها، فلم يعد قادرا على متابعة ما يحصل بسلبيّة، وقلب الطّاولة هنا لن يكون على مفسدي فرحته ولا على المتسبّبين في تعفّن نظام الانتدابات في الوظيفة العمومية ولا على المشرفين على المناظرات العموميّة ولن يكون بتشكيل خليّة أو جمعيّة تدعو لكشف الحقائق وشفافيّة المعلومة والامتحانات أو بمراسلة مجهولة الهويّة إلى السّيد رئيس الجمهوريّة القادم للتّوّ إلى قصر قرطاج، كلاّ لن يكون الأمر كذلك، بل سيكون قلب الطّاولة على أحلام طالما سكنته، على هويّة فهم أنّه غير قادر على نحتها باستقلالية عن نظام فاسد مهترئ ومتآمر. لقد قرّر صاحبي أن يقنع ابنه بكلّ الوسائل أن ينقطع عن الجامعة وأن يأتي معه إلى ورشته يتعلّم في كنفها كيف يفتّق أحجبة العالم وأسرار الكينونة الاجتماعية بعيدا عن أوهام طالما سوّقت لها أجهزة الأنظمة القائمة لتبرير أسباب وجودها وتشريع أسس التراتب الاجتماعي القائمة.
هنا مرّت الحكاية من مجرّد قصّة شخصيّة تهمّ أحداثها مواطنا بعينه إلى قصّة مجتمع ونظام بالنّسبة لي، إنّها قصّة المدرسة والتّمايز الاجتماعي وتحوّلات البنية الاجتماعية والطّبقيّة في بلادنا، والتي انبثقت من سياقات تحوّلاتها انتفاضة الشّعب في ديسمبر 2010 وبقيت نهاياتها مفتوحة لم ترتسم بعد ملامحها الأساسيّة.
لقد أبرز العديد من الدّارسين، وعلى رأسهم علماء الاجتماع، كيف أنّ المدرسة كانت من بين أهمّ مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة، وأنّها بوحدة برامجها وتساوي الحظوظ بين كلّ التّلاميذ مهما كانت انتماءاتهم الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا كبيرا في التّقليص من حدّة الصّراعات الاجتماعية وتعطي الفرصة للجميع للصّعود الاجتماعي والتّموقع في أعلى المراتب الوظيفيّة، وقد عزّز من هذا الدّور اعتبار الشّهائد المدرسيّة والجامعيّة جوازات المرور إلى المواقع المطلوبة في سلّم الوظيفة العموميّة خاصّة، ولكن كذلك في مواقع العمل والإشراف في القطاع الخاصّ، سواء في تونس أو في العالم. لقد جعلت المدرسة في تونس، وطيلة عقود من الزّمن، من الرّأسمال المدرسي مفتاح النّجاح الاجتماعي، وكانت حظوظ الجميع شبه متساوية في الحصول على هذا الرّأسمال، لكنّ ذلك ومنذ نهاية القرن الماضي تقريبا لم يعد القاعدة، وبدأنا في تعداد الآلاف من العاطلين عن العمل من بين أصحاب الشهائد الجامعيّة، فكثر الانقطاع المدرسي في مراحل الدّراسة الأولى، وبدأت احتجاجات أصحاب الشهائد بصفة فردية في البداية ثمّ أنشؤوا لهم اتّحادا يجمعهم ويدافع عنهم وعن قضاياهم، ولكنّ الحلول كلّها كانت وقتيّة ولم ترتق إلى مستوى الانتظارات، لأنّ المخطّطين لم يفهموا بعد أنّ أزمة المدرسة إنّما تعكس قبل كلّ شيء أزمة نظام في كلّ مستوياته.
إنّ من ينظر اليوم إلى المناظرات التي أشرنا إليها وغيرها يفهم جيّدا أنّنا دخلنا بعمق في منطق السّوق، السّوق الذي لا تعرض فيه إلاّ السّلع التّبادليّة، والتي لكلّ منها ثمن، وتدخل في منافسة وفي منطق العرض والطّلب، وقوانين المنافسة هنا لا تحترم، بل هي توضع لخرق قبل كلّ شيء من قبل واضعيها. لقد اكتسح السّوق اليوم كلّ المجالات الإنتاجية، المادية منها والرمزيّة، ولم تكن المدرسة ولا القيم العامّة وما ارتبط بها بمعزل عن هذا الاكتساح. فكانت النّتيجة تهاوي قيمة التساوي في الحظوظ المدرسيّة تماما، وخاصّة مع تحويرات في الأنظمة التربوية لا تزال تتمّ بعيدا عن الصّيغ التّشاركية، التي يكثر الحديث عنها تقليدا، ولكن دون تطبيق على أرض الواقع، فدخل التّعليم الخاصّ في كلّ المستويات، ومنذ المراحل ما قبل المدرسيّة وإلى حدود الجامعة، منافسا للتعليم العمومي المتهاوي في بنيته الأساسيّة وفي الفوضى التي تسوده تنظيما وبرامج، فضلا عن تمكين أصحاب الاستثمار في التعليم الخاص من استغلال إمكانات الدّولة وتجهيزاتها وحتّى مواردها التقنية والبشريّة، دون ثمن يعادل حقيقة تلك الإمكانات المستغلّة.
وحدّث أيضا ولا حرج عن الدّروس خارج المدرسة، وعن هذا الرُّهاب الذي يعاني منه التلاميذ والطّلبة وأولياؤهم، وهو يستنزف كلّ طاقاتهم الذّهنية والزّمنية والجسديّة والماليّة، هذا الطّاعون الذي يزيد تدريجيا في تعميق الهوّة بين حظوظ أبناء الشعب في تلقّي خدمات احتكرتها الدّولة لعقود، وفجأة سادتها الفوضى ودخلها «الموازي»، مثلما اقتحم كلّ مجالات النّظام في تونس، حيث بتنا نجد الموازي في كلّ شيء، كالطفيليات، في الصحة والنقل والتعليم والاقتصاد والرياضة... وهذا هو الخطر الحقيق برأيي، وهو أن يكون الأمر ممنهجا، أمر إحلال الشرعي بما لا شرعية له سوى التفكير في هدم المكتسبات وإسقاط أسس البناء كلّه على رؤوس الجميع فتكون الفوضى الخلاّقة مبرّرا لإحلال واقع آخر يكون فيه المهندسون أولئك الذين فشلوا لعقود بل ولقرون في تأسيس بدائلهم التي لم تجد لها مكانا في واقع لم يفقهوا بعد أنّه في تغيّر مستمرّ ويقتضي بالتالي أشكالا تنظيميّة متغيّرة ومتطوّرة باستمرار.
تحوّلت المدرسة هكذا، ومعها الجامعة بالطّبع من فضاءات للتأهيل للمواطنة إلى مؤسّسات استدراج وتهدئة وتسويق للأوهام، فيكون الاصطدام بين المنشود والموجود عنيفا، وتُضحي المؤسسات التي يفترض أنّها تنشر المساواة والسلم الاجتماعيين، مبرّرة للعنف الرّمزي المنهجي، لذلك كان الرّدّ أعنف، بردود الفعل المتمحورة حول الذّوات، وحول الأجساد (مخدّرات، عنف جسدي، انتحار، قوارب الموت...) إلى ردود على المحيط القريب («غزوات» لشلّة من معهد على أخرى من معهد آخر، تحطيم وكسر للمنشئات العموميّة وللتجهيزات داخل المعاهد، بذاءة مستشرية ومقصودة في الفضاء العام وفي المدرسة والجامعة والملعب...)، فكيف يمكن أن نقيّم مآلات هذا الوضع؟ إنّه الفشل التّامّ للأهداف التي من أجلها تأسست المدرسة والجامعة، إنّه الانحراف عن المسارات التي كان يفترض أن تسلكها هذه المؤسسات خدمة للمجتمع وللأجيال القادمة.
إنّنا أيها السّادة والسيدات أمام وضع لم يعد يحتمل الانتظار أكثر، وأخشى ما نخشاه أن نفيق يوما فنجد كلّ ما بناه آباؤنا أثرا بعد عين. لقد بدأت الهجرة الفعليّة الممهّدة للفراغ، هجرة العقول، فهجرة المدرّسين بناة تلك العقول فبحث أبنائنا عن تعليم أفضل خارج الحدود. ولعلّكم بدأتم تقرّون بضرورة الإصلاح، اصلاح المنظومة التربوية والجامعيّة مثلما شُنّفت أسماعنا بسماعه منذ سنوات، فنجيبكم أنّ الأمر لا يقتضي إصلاحا، إنّه يتطلّب ثورة، فأن نصلح مؤسسة في محيط ملوّث كما لو قمنا بإصلاح غرفة في بناء متهاو. لن يصلح التّعليم ما دامت الإدارة على تلك الدّرجة من الانخرام، وما دام النّظام القائم فقد الموجّهات التي يجب أن تقود لخدمة المجتمع بأكمله لا خدمة مصالح فئات ضيّقة دون أخرى.
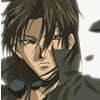
ben-3006- الاشراف العام

- الجنس :

عدد المساهمات : 923
نقاط : 6522
تقييم : 4037
تاريخ التسجيل : 13/01/2014 - -----
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى




